الطبيعانية وعدم القابلية للمقارنة: دراسة في طبيعانية كواين 3
3- الطبيعانية والنزعة الشكية
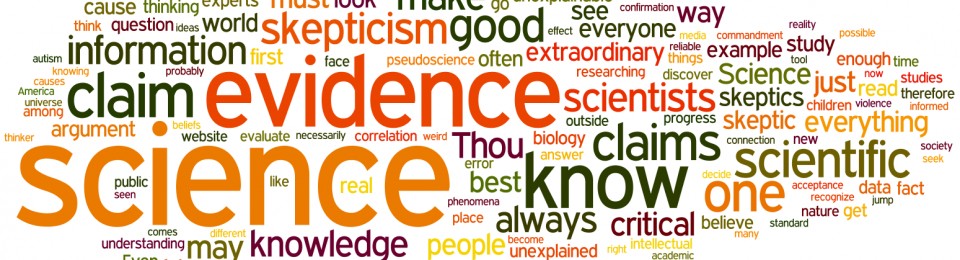
3- هل الطبيعانية هي الإطار الإبستمولوجي الأفضل لاستيعاب نتائج العلم؟!
-
(3.1)- جدل حول واقعية المعرفة العلمية
في الغالب يؤمن الجميع بالحقائق العلمية خصوصًا تلك التي تقترب من الحس المشترك أو تتعلق بوقائع يومية، لا أحد يشك أن القفز من النافذة من بناية مرتفعة لن يؤدي إلى الموت المحقق، أو أن الشمس ربما لن تشرق في الصباح، ولكن نجد أن البعض – رغم ذلك – يتشكك في الحقائق العلمية التي تقع على مسافة بعيدة من الحس المشترك، مثل نظرية التطور أو نشأة الكون (وقد يصل الأمر إلى حد التشكك في كروية الأرض!).
يعتبر هؤلاء المتشككون أن العلم ليس وسيلة مضمونة للوصول إلى الحقيقة، وأن هناك وسائل أخرى (مثل الحس المشترك، أو الحدس أو الوحي) تقدم حقائق أكثر ضمانًا، وعندما تتعارض مع العلم يجب ترجيحها، على الناحية الأخرى نجد أن البعض الآخر يقبلون نتائج العلم بالكامل، أي أنهم يقبلون أن العلم طريق إلى حقيقة من نوع ما، ولكنهم يعتبرون المعرفة العلمية محدودة المجال، وتحتاج إلى التأسيس والتسويغ على نوع أكثر صلابة ويقينية من المعرفة، فهناك أنواع أخرى من المعرفة للوصول لأنواع مختلفة من الحقائق وتلك لا سلطان للعلم التجريبي فيها، ولها طرق وصول ومناهج مختلفة.
عادةً ما يتم الادعاء أن المعرفة التجريبية ناقصة أو محدودة أو في حاجة إلى التأسيس من الخارج، أحيانًا عن طريق استدعاء دعوى نقص التحديد خصوصًا في شكل أطروحة عدم القابلية للمقارنة عند بول فايرباند و توماس كون ومن ثم الادعاء أن المعرفة العلمية “نسبية” وغير واقعية ومن ثم لا تقدم حقائق ولكن “تصورات” عن الواقع تلعب العوامل السياسية والاجتماعية دورًا كبيرًا في تشكيلها، ومن ثم تكون نتيجة القياس -الفاسد- النهائية هي: تجريد العلم التجريبي من كامل سلطته الإبستمولجية، واعتباره “وجهة نظر” عن الحقيقة وليس الحكم الأخير للحقيقة. (وقد تحدثنا سابقًا عن الحل الكلاني لمشكلة نقص التحديد).
وأحيانًا أخرى، من خلال استدعاء مشكلة الاستقراء أو غياب التأسيس المنطقي، فإذا كان لا شيء في العقل إلا وقد مر عبر الحواس أولًا، وإن كانت يقينيةُ وموثوقية القوانين العلمية الكلية تعتمد على المنهج الاستقرائي الذي يعتمد على مبدأ العلية، وبما أن أحدًا لم يرَ أو يلمس العلية، فبالتالي تكون المعرفة العلمية معلقة في الفراغ، ويكون الشعار التجريبي مؤدٍّ إلى الانهيار الذاتي للمعرفة التجريبية، فتكون المعرفة التجريبية غير يقينية بالمقارنة بالرياضيات والمنطق. يقول د. زكي نجيب محمود “وقد كان اليقين في الرياضة والمنطق من أهم الدعائم التي يستند إليها الفلاسفة العقليون حين ينكرون على أصحاب المذهب التجريبي اعتمادهم على الحواس في كسب المعرفة؛ إذ كانوا يقولون من جهة إن القضية التي نعتمد فيها على معطيات الحواس لا تبلغ درجة اليقين، ومن جهة أخرى إن يقين الرياضة أقوى دليل على أن العقل – لا الحواس- هو مصدر المعرفة الصحيحة.
وأما موقف الفلسفة التجريبية إزاء هذه النقطة فهو أن ترد بأحد جوابيين: فإما أن يقول الفيلسوف التجريبي إن قضايا المنطق والرياضيات ليست يقينية ولا ضرورية كما هو شائع عنها، وإما أن يعترف بيقينها وضرورتها لكنه يضيف إلى ذلك أنها لا تصف شيئًا من الواقع ومن ثم كان لها ما لها من يقين وضرورة.
إعلان
وقد أخذ أصحاب المذهب الوضعي المنطقي بالجواب الثاني، وهو أن هذه القضايا لا يتوقف تحقيقها -مثل قضايا العلوم الطبيعية- على التجربة، لأنها تحصيل حاصل، ولا تفيد شيئًا عن طبيعة الواقع، ومن ثم كان لها اليقين والضرورة.
وأما “جون ستيوارت ميل” فيأخذ بالجواب الأول، فزعم أن قضايا الرياضة والمنطق ليست ضرورة ولا يقينية، وأنها -كغيرها- تعميميات استقرائية قائمة على عدد كبير جدًا من الشواهد الجزئية؛ وكون عدد الشواهد الجزئية كبيرًا جدًا هو الذي جعلنا نؤمن بيقينها وضرورتها.”[i]
وربما كانت أشهر المحاولات جرأة في الدفاع عن المعرفة التجريبية هي محاولة جون ستيوارت ميل؛ فقد تعامل “ميل” مع مشكلة الاستقراء وعدم تأسيس الاستدلال الاستقرائي منطقيًا من خلال افتراض ثلاث فرضيات هي 1) السببية، 2) اضطراد الطبيعة 3) والحتمية، يكون بها الاستدلال الاستقرائي مبررًا منطقيًا. ولكن كيف نستطيع أن نبرر هذه الفرضيات نفسها؟!
الجواب كان عند ميل هو: “بالاستقراء نفسه”. ولكنه استقراء من مستوى أعلى، أننا نطمئن لسلامة منهجنا ومعرفتنا الاستقرائية عن طريق استقراء أعلى، فنجاح الاستقراء في التوصل إلى القوانين العلمية الشاملة والتي أثبتت نجاحها التطبيقي وأنها فاعلة أينما اختبرناها وبلا استثناءات، هو بلا شك دليل كافي على اضطراد الطبيعة والحتمية والعلية، وقد أدت هذا الإجابة إلى ردة فعل عنيفة من نقاد ميل حتى أن مذاهب كاملة قد قامت كردة فعل عكسية لتجريبية ميل، كانت مشكلة النقاد الكبرى مع ميل –كما هي مع كواين والإبستمولجيا المتطبعة بشكل عام- هي مشكلة الدوران المنطقي، فكيف نبرر الاستقراء بالاستقراء، فالإبستمولجيا التأسيسية Foundationalism تطلب تأسيس المعرفة على مبادئ معرفية قبلية لا يرقى إليها الشك وسابقة منطقيًا على كل ما سواها، وكانت محاولة ميل –في رأيي الشخصي- محاولة مبدئية للانعتاق من التأسيسية الديكارتية، (ومثلها محاولة أوجست كونت، الذي اعتبره كواين ممثل الفلسفة الطبيعانية في القرن التاسع عشر [ii])
وفي ذلك يقول وليم كيلي رايت: “يتهم الفلاسفة العقليون ميل بأنه يدور في حلقة مفرغة؛ لأنه يستخدم هذه الفروض، ثم ينظر إليها على أنها فروض راسخة تمت البرهنة على صحتها لأن التجربة تطابقها، وربما يقال دفاعًا عن ميل إنه يجب على كل فيلسوف أن يبدأ بفروض لا يستطيع أن يبررها إلا عن طريق النجاح الذي تؤكد به تجربة أبعد نتائج مستمدة منها. وبما يكون الدوران في حلقة مفرغة -إذا سميناه كذلك- واضح عند ميل أكثر مما هو كذلك عند ديكارت، وكانط، وهيجل؛ غير أن ذلك لا يمكن أن ننسبه إلا لواقعة تقول أنه أكثر صراحة” [iii]
ورغم أن أحدًا لا يتبنى اليوم فلسفة جون ستيوارت ميل بالكامل، إلا أن الفلسفة الطبيعانية التي يمكن النظر إليها كاستمرار للتجريبية الوضعية هي اكتمال وتطوير للنزعة اللاتأسيسية التي وضع إرهاصاتها أوجست كونت وجون ستيوارت ميل، فالمنهج العلمي يسوغ بعضه بعضًا، ولا يحتاج إلى التأسيس من خارجه، يقول كواين:
“والطبيعانية ترى العلم كطريق استجواب للحقيقة، غير معصوم وقابل للمراجعة، لكنه غير مُساءل أمام أي محكمة فوق-علمية، وليس في حاجة إلى أي تسويغ غير اعتماده على الملاحظة والمنهج الفرضي الاستنباطي”[iv]،
حيث إن كواين يستبعد النزعة التسويغية “Justificatory” من الأساس، ويرفض إمكان الفلسفة الأولى التي تسوغ العلم على أسس أولية سابقة عن العلم، (وهو في هذا يختلف عن ميل) وسنناقش الموقف الطبيعاني بالتفصيل في فقرة لاحقة.
أما معظم الفلاسفة التجربييين المعاصرين المشغولين بالجانب التسويغي “Justificatory” للمعرفة التجريبية فيتبنون أسلوبًا قريبًا من أسلوب جون ستيوارت ميل في الدفاع عن واقعية المعرفة العلمية من خلال تسويغها عن طريق الصعود درجة أعلى في التجريد، فمثلًا هناك من يتشكك في موثوقية الاستقراء Induction لأنه غير مؤسس منطقيًا وبالتالي الشك في الحقيقة العلمية التقريبية، فيرد عليهم الفلاسفة أننا نبرر المعرفة الاستقرائية بنوع أعلى من الاستقراء وهو ما يعرف بالاستقراء من المستوى الثاني Meta-Induction أو الاستقراء المتفائل Optimistic Induction، والذي يقول أننا عندما ننظر إلى النجاح الذي حققه المنهج العلمي الاستقرائي (حتى الآن) في التنبؤ الناجح بالظواهر وتسخيرها لصالح الإنسان في صورة المنجزات الحضارية، يكون لدينا أسباب جيدة للاعتقاد أن المنهج العلمي الاستقرائي سيستمر في النجاح في المستقبل وأنه وسيلة مضمونة إلى الوصول إلى الحقيقة التقريبية (وهذا في حد ذاته استدلال استقرائي).
وهناك من يتشكك في صلاحية مبدأ الاستدلال لأفضل تفسير ممكن (Inference to the Best Explanation IBE) لأن أفضل تفسير متاح لا يضمن منطقيًا أنه التفسير “الصحيح” الذي يتطابق مع الحقيقة، وبالتالي ننتهي إلى حالة من اللاواقعية Anti-realism فيرد عليهم الفلاسفة بأننا نبرر تفسيراتنا العلمية باستدلال لأفضل تفسير ممكن من المستوى الثاني Meta- IBE، فأفضل تفسير ممكن لنجاح المنهج العلمي هو كون المعرفة العلمية معرفة واقعية، وأكثر المدافعين عن وجهة النظر الأخيرة هو الفيلسوف هيلاري بوتنام عبر ما أصبح يعرف بحجة المعجزة وهي التي تقول أن الواقعية هي أفضل تفسير أنطولوجي ممكن للمعرفة العلمية وإلا يصبح نجاح المنهج العلمي معجزة. (لاحظ معجزة هنا لا تعني الاستحالة المنطقية).
ولكن هل الالتجاء إلى المستوى الثاني ينهي المسألة أم يرد الأسئلة إلى مستوى أعلى ويتركها هناك بلا إجابة؟!
-
(2)- عدم القابلية للمقارنة من المستوى الثاني Meta-Incommensurability
بالنسبة لبعض لمذاهب الفلسفية (مثل العقلانية والمثالية والفينمينولوجيا)؛ لا يعد هذا الرد مقبولًا، فالخلاف بين التجربية والفلسفات الأخرى يتعدى الخلاف على نظريات بعينها، ولكنه يصل إلى المبادئ الإبستمولوجية والميتافيزيقية التي يتحدد على أساساها ما هو مسوغ وما هو غير مسوغ، ماهو ضروري، وما هو ليس كذلك، ما يعد تفسيرًا كافيًا وما لا يعد.
في هذا يقول ريكيتس: “إن الاختلاف بين كواين وتشومسكي ليس تعارضًا لنظريات متنافسة منصبة على معطيات بعينها، بل اختلافًا على ما يعد معطيات، وعلى المصطلحات التي نسلم بها لتمثيل المعطيات” [v] فالخلاف على معنى التفسير نفسه بالإضافة إلى حدود ما هو معطى كموضوعٍ للتفسير.
ولكن عندما ينشأ خلاف جوهري بين وجهتين من النظر، نموذجين إبستمولجيين وميتافيزقيين متعارضين فيما بينهما أشد التعارض، فكيف نقارن بينهما؟! خصوصًا إذا كنا نعلم أن المبادئ الإبستمولوجية والأنطلوجية الأكثر بساطة هي ضرورية وسابقة على أي نوع من الاستدلال، وهي التي تحدد مدى ما هو معطى وتشكل الأطر الذي يتكون فيها الحكم، فكل حكم هو حكم داخل مخطط مفهومي، وهذا ما يدركه كواين جيدًا عندما يقول: “هذا، خاصية للميتافيزقيا -على ما أعتقد- إذا كان لأحدهم أن يعتبر عبارة ميتافيزيقية صحيحة بأي حال فإنه لابد أن يعتبرها صحيحة بشكل تلقائي وبديهي Trivially True، فالنظرية الأنطولوجية تقع في قلب المخطط المفهومي الذي يفسر به المرء جميع التجارب، حتى العادية واليومية منها، وعندما يحكم المرء على العبارة الأنطلولوجية من داخل المخطط المفهومي الخاص به – وكيف يمكن الحكم عليها إلا من داخل المخطط المفهومي؟!- تكون قائمة بذاتها وبلا أي حاجة إلا للتسويغ”[vi]
هنا ننتقل من عدم القابلية للمقارنة Incommensurability إلى ما وراء عدم القابلية للمقارنة Meta-Incommensurability أو عدم القابلية للمقارنة من الدرجة الثانية، وهو مصطلح استخدمه فيلسوف العلم الألماني بول هويننين-هوين Paul Hoyningen-Huene للحديث عن عدم القابلية للمقارنة في المستوى الميتافيزقي والأنطولوجي مثلًا عند المقارنة بين الواقعية والمثالية. إن الأمر هنا لا يعد اختلافًا حول نظريات علمية متنافسة ولكن بين مخططات مفهومية متكاملة بكامل مبادئها الإبستمولوجية والميتافيزيقية، وإذا كنا نستطيع المقارنة في المستوى الأول أي بخصوص النظريات العلمية، فهل نستطيع أن نفعل نفس الشيء بخصوص عدم قابلية المقارنة من المستوى الثاني أي بخصوص المبادئ الإبيستمولوجية والميتافيزيقية الأكثر بساطة؟!
إن الإطار الإبستمولوجي والميتافيزقي ضروري وسابق على أي حكم معرفي يصدره المرء، ولكنه رغم ذلك قابل للتغيير والمراجعة، كما اقتبسنا من كواين سابقًا: “ولكن على الرغم من ذلك لا يجب أن نقفز إلى النتيجة الجبرية القائلة أننا أسرى مخططنا المفهومي الذي نشأنا وترعرعنا عليه، بل إننا يمكننا تغييره، جزءًا جزءًا ولوحًا لوحًا، وخلال ذلك ليس هناك ما نقف عليه إلا مخططنا المتطور نفسه، ولقد شبه نيوراث تشبيها مصيبًا مهمة الفيلسوف بمهمة البحار الذي يتوجب عليه إعادة بناء سفينته في عرض البحر، يمكننا تحسين مخططتنا المفهومي، فلسفتنا، جزءًا بجزءٍ، في الوقت نفسه الذي نستمر في الاعتماد عليه” [vii]
ومما لا شك فيه بالنسبة للنزعة الكلانية أن أكثر مبادئنا الإبستمولوجية والأنطلوجية ببساطة هي نفسها جزء من الشبكة المعرفية، وليست في مستوى أعلى محصن من النقد، لذا هي من حيث المبدأ معرضة للمراجعة، وعندما نراجعها فإننا لا نستند إلى أي شيء قبلي من درجة أعلى، ولكننا نغيره بالاستناد إلى بقية علمنا ومعرفتنا.
إننا نقارن بين النماذج الأنطولوجية المتنافسة كما نقارن بين النظريات العلمية استندانا إلى معاييرنا التطبيقية والبرجماتية، فالنظريات الأنطلوجية نفسها تقف على قدم المساواة مع النظريات العلمية، فليس ثمة تراتبية منطقية في الشبكة المعرفية بحيث تمثل بعض القضايا مبادئ أولية غير قابلة للمراجعة يقول كواين “إن قبولنا لنموذج أنطولوجي متساوٍ من حيث المبدأ مع قبولنا لنظرية علمية، فمثلًا في نسق الفيزياء: نحن نتبنى حتى الآن – إذا كنا عقلانيين – النموذج التخطيطي الأكثر بساطة، الذي يمكن فيه للأجزاء المتفرقة من الوقائع الخام ان تلتئم وتتراتب، بينما نسقنا الأنطولوجي يتحدد عندما نتوصل إلى المخطط التصوري الشامل الذي يستوعب العلم بكامله بالمعنى الأوسع، الأسئلة الأنطلولوجية بناؤنا على هذا التصور، هي على قدم المساواة مع أسئلة العلم الطبيعي.[viii]
إن النظرية المنافسة (العقلانية مثلًا) تدّعي أن التجريبية (الطبيعانية) ليست هي الإطار الإبستمولوجي الأفضل لاستيعاب نتائج العلم، فرغم أن العقلانية تقبل نتائج العلم بالكامل ولكنها لا تجد أنه يلزم عن قبول المعرفة العلمية أو تسويغها أن نصل للادعاء الإبيستمولوجي التجريبي ونرفع الشعار: “لا شيء في العقل إلا وقد مر عبر الحواس أولًا” “Nihil est in intellectu quod non prius in sensu” فهناك معرفة بعدية نكتسبها بالحواس ولكن هناك أيضًا معارف قبلية وضرورية (ربما مصممة بيولجيًا في الدماغ كما يقول تشومسكي، أو مقولات قبلية في العقل (العقل هنا لا تعني الدماغ) كما يقول كانط، أو ربما هي مكتسبة بالحدس)، وقبول المعرفة العلمية لا يلزم عنه أبدًا رفض هذه الدرجات الأخرى من المعرفة بل إن المعرفة التجريبية نفسها في حاجة إلى التأسيس على مبادئ منطقية بديهية.
فكيف نقارن بين هذا الادعاء وبين الفلسفة التجريبية؟!
إننا نقارن بين هذه النظريات الإبستمولوجية والميتافيزيقة تمامًا كما نقارن بين النظريات العلمية بالاستناد إلى الغايات البرجماتية والمبادئ التنظيمية، فيمكننا أن نقول أن المذاهب الأخرى (الثنائية، العقلانية، المثالية) تضع في التزامها الأنطولجي أكثر مما هو ضروري لحفظ الظواهر، فإذا التزمنا مبدأ الاقتصاد التفسيري والأنطولجي لوجدنا أن الطبيعانية هي الأكثر اقتصادًا تفسيريًا، فالتأسيسات الأخرى كلها تفترض كيانات أنطولوجية أكثر مما يفترض المذهب الطبيعي لتفسير العالم، كما تقدم إطار نظري إبستمولوجي أكثر تعقيدًا مثلًا: الثنائية الأنطولوجية تفترض مقولتين للوجود، وجود مادي ووجود عقلي، والواقعية العقلانية تفترض أنواعًا غير ضرورية من الكائنات الذهنية مثل المعاني والقضايا والعوالم الممكنة، وكذلك يفترض كل منهم ثنائية منهجية، أي درجات مختلفة للمعرفة بطرق وصول مختلفة، وكل هذا غير ضروري ومعقد، على العكس هناك واحدية منهجية تقدم ادعاءات معرفية وأنطولوجية أبسط وتؤدي نفس الوظيفة التفسيرية.
وربما نسأل: ولكن ماذا إذا قال أحدهم: “ولماذا نقبل الاقتصاد التفسيري كمبدأ تنظيمي وكقاعدة منهجية من الأساس؟ ومن قال أن التفسير الأبسط هو دائمًا التفسير الأفضل؟ ومن قال أن التفسير الأفضل هو دائمًا التفسير (الصحيح)؟”
وقد يعتقد بعض التجريبيين أن تلك المبادئ التنظيمية يُفترض أنها في فئة منطقية أعلى وبذلك تعتبر سابقة بالنسبة لسائر النظريات الإبستمولوجية والأنطولوجية والعلمية، فهي مجرد قواعد إرشادية أو توصية منهجية ومعيار لترسيم الحدود بين المعنى أو اللا معنى أو العلم واللا علم، (مثل الوضعيين المنطقيين) ولكن بالتأكيد الفيلسوف الطبيعاني الذي يتبنى النزعة الكلانية لا يستطيع تبني مثل هذه الادعاء، فمبدأ الكفاية التفسيري والاقتصاد الأنطلولوجي وسائر القواعد المنهجية هي نفسها جزء من الشبكة المعرفية وليست في درجة أعلى، بالتالي تكون أيضًا عرضه للمراجعة والتعديل (لذا فإن محاولة الفيلسوف لاري لودن Larry Laudan لرفض دعوى نقص التحديد بالاستناد إلى مبادئ تنظيمية أو ما يسميه implicative principles of good reasoning لا ينسحب على فلسفة كواين التي تقع النزعة الكلانية في المركز منها). هذه المبادئ نفسها مسوغة عن طريق علاقتها ببقية النسق المعرفي، فمعيار صلاحية مبادئنا الإبستمولجية وقواعدنا المنهجية التي توصلنا إليها عبر الاصطدام بالواقع والتجربة والخطأ والتعديل، هو نجاحها في إنتاج المعرفة العلمية القادرة على التبنؤ، فمبادؤنا العلمية وقواعدنا المنهجية ليست اعتباطية وليست وليدة نزواتنا وأهوائنا، ولكنها أفضل إطار منهجي منتج نستطيع الوصول إليه لإنتاج الصرح العلمي، الذي يبرر بعضه بعضًا.
وكما رفضنا دعوى عدم القابلية للمقارنة فإننا نرفض كذلك دعوى عدم القابلية للمقارنة من الدرجة الثانية، والسبب بسيط، وهو أنه لا توجد درجة ثانية في الإبستمولوجيا الطبيعية، فليس ثمة فلسفة أولى، والمبادئ الإبستمولوجية والالتزامات الأنطولوجية هي نفسها جزء من الشبكة المعرفية وهي قابلة للمراجعة من حيث المبدأ، ولكنها لا يمكن أن تراجع إلا من داخل المخطط المفهومي العلمي نفسه، أي إننا بالاعتماد على أجزاء في شبكتنا المعرفية نراجع أجزاء أخرى، حتى وإن كانت هذه أبسط المبادئ الإبستمولوجية والقواعد الإرشادية (حتى وإن كانت قوانين المنطق نفسها!)، ولكن ينتج عن هذه الإجابة سؤال آخر وهو: إذا كانت الإبستمولوجيا (التي يفترض أنها تسوغ العلم) جزءًا من العلم، و إذا كنا نرفض المشروع التأسيسي الديكارتي، فإننا نجد أنفسنا نعود إلى السؤال الأفلاطوني القديم: كيف ندافع عن المعرفة أمام الشك السفسطائي؟! وما الذي يمنح معرفتنا الثقة واليقين (النسبي)؟!
فكيف إذن نواجه النزعة الشكية تبعًا للنزعة الكلانية والفلسفة الطبيعانية؟!
- (3)- الإبستمولوجيا المتطبعة Epistemology Naturalized والنزعة الشكية Skepticism
الإبستمولوجيا جزء من العلم وليست سابقة عليه، يقول كواين: “إن الإبستمولوجيا ليست في النهاية إلا فرع من علم النفس” ولكن هذا لا يفقدها دورها المعياري، يقول كواين: “تطبيع الإبستمولوجيا لا يعني التخلي عن الجانب المعياري والقنوع بمجرد وصف محايد للعمليات الجارية، بالنسبة إلى الجانب المعياري في الإبستمولوجيا هو عملية تقنية هندسية، تكنولوجيا السعي للحقيقة Technology of truth seeking أو باستخدام مصطلحات إبستمولوجية أكثر دقة: تكنولوجيا التنبؤ” [ix]
ويعلق تشيس رين: الإبستمولوجيا المتطبعة عند كواين هكذا تكون “محتواة” في علم النفس كموضوع فرعي، ولكن كواين يؤكد أيضًا، أن هناك معنى، على الرغم من ذلك، تكون به الإبستمولوجيا المتطبعة “تحتوي” باقي العلم كله. فنظرياتنا واعتقادتنا عن العالم والتى تكَوِّن علمنا هي جزء من موضوع الإبستمولوجيا، ولأن العلم و الإبستمولوجيا كلاهما يحتوي الآخر، فإن كل منهم يضع حدودًا للآخر، فليس فقط العلم هو الذي يجب أن يجتاز الشروط الإبستمولوجية، بل وأيضًا نظرياتنا الإبستمولوجية يجب أن تلائم باقي نظرتنا العلمية عن العالم. Scientific worldview ” [x]
ولكن إذا كانت الإبستمولوجيا جزءًا من العلم والعلم نفسه مسوغ عن طريق الإبستمولوجيا، ألا يوقعنا ذلك في الدور؟!
ويقول د.صلاح إسماعيل: “وربما يتساءل المرء كيف يستطيع الإبستمولوجي الطبيعي استعمال النتائج النهائية للعلم لتسويغ العلم؟! ألا يوقعنا ذلك في الدور؟!
إن إجابة كواين تظهر اختلافًا مهمًا بين الإبستمولوجيا الطبيعية والإبستمولوجيا التقليدية، ويتضح الاختلاف عند معالجة النزعة الشكية. وكان الرأي في الإبستمولوجيا التقليدية في صورتها الديكارتية إننا لكي نرد على الشاك فمن غير المشروع أن نستفيد من نتائج العلم، لأننا لو استفدنا من هذه النتائج في ردّنا، لكان هذا معناه اجتنابًا للسؤال ووقوعًا في الدور، إذ كيف نرد عليه من شيء يضعه موضع الشك؟! ومن هنا قرر ديكارت في الرد على الشاك رفض كل الأشياء التي تتعرض للشك، والبداية من نقطة لا يجد الشك إليها سبيلًا.
ولكن كواين يجد أن طريقة ديكارت في معالجة النزعة الشكية تسيء فهم المشكلة الشكية، لأن المشكلة الشكية تنشأ من داخل العلم، أن الشك يحض على نظرية المعرفة، والمعرفة أيضًا هي ما حض على الشك، والنزعة الشكية فرع من العلم، فالأوهام تكون أوهامًا فقط بالنسبة لقبول سابق لأجسام حقيقية تتعارض معها، إنّ افتراض (أسطورة) الأجسام هو بالفعل نظرية فيزيائية بدائية، والعلم الفيزيائي البدائي، أعني الحس المشترك المتعلق بالأجسام يكون مطلوبًا هكذا على أنه نقطة الانطلاق للنزعة الشكية.
إن العلم يثبت لنا كيف أن جوانب متنوعة من وجهة نظر حسنا المشترك عن العالم ربما تكون خاطئة إلى درجة أننا نصل إلى طرح السؤال: هل يجوز أن نكون مخطئين تمامًا في الطريقة التي نرى بها العالم؟! وإن شئت أن نضع هذه النقطة بطريقة أخرى، قل إن نجاحنا في فهم العالم، وبالتالي جواز اختلاف المظهر والحقيقة، هو على وجه الدقة الذي يثير الأسئلة الشكية في المقام الأول. ويجوز إذن أن نستعمل موارد العلم استعمالًا مشروعًا للرد على الأسئلة التي يطرحها العلم نفسه، ومن ثم يتعين علينا أن نفهم السؤال المتعلق بكيف تكون معرفتنا ممكنة على أنه سؤالٌ تجريبي، سؤال عن الكيفية التي يجوز بها لمخلوقات مثلنا (مع الأخذ بعين الاعتبار ما تخبرنا به أفضل نظرياتنا العلمية الحالية عما عسانا أن نكون (أن نتوصل إلى اعتقادات دقيقة وصحيحة حول العالم) مع الأخذ بعين الاعتبار ما تخبرنا به أفضل نظرياتنا العلمية الحالية عما عسانا أن يكون العالم)
وطالما أن الشاك يستعمل الدعاوي العلمية في الهجوم على العلم، فإن المدافع عن العلم يكون حرًا في استعمال النظريات العلمية في الدفاع عن العلم، وبالتالي فإن خشية الوقوع في الدور لا مجال لها” [xi]
يقول كواين : “إن عملية تطبيع الإبستمولوجيا، كما وضعت خطوطها، هي تقييد وتحرير معًا، فالبحث القديم عن أساس للعلم الطبيعي، أرسخ من العلم نفسه، تم التخلى عنه، وهذا الشيء هو التقييد، أما التحرير فهو الوصول الحر إلى موارد العلم الطبيعي من غير خوف من الوقوع في الدور”[xii]
إن الإبستمولوجيا الطبيعية لهي منذ الأساس موقف ضد النزعة الأسسية في التسويغ، والعلم يعتبر الشك المطلق مستحيلًا، كذلك التأسيس المطلق على نقاط مطلقة اليقين، فكل شك يفترض قدر من المعرفة، والأسئلة الشكية نفسها لا تكون ممكنة إلا من داخل العلم، فكل حكم هو حكم داخل خطط مفهومي “وكيف يمكن الحكم إلا من داخل المخطط المفهومي؟!”، فإننا لا نستطيع أن نمضي في الشك إلى ما لانهاية، فلابد أن يتوقف السؤال عند حد ما (كما يقول فنجنشتين) أو يدور في دوائر مفرغة، وهذا الحد النهائي للتفسير هو الإيمان بالواقع والحس المشترك، فالعلم استمرار للحس المشترك أو هو الحس المشترك وقد أصبح واعيًا بنفسه، (ومن ثم يستطيع أن يتطور و يراجع نفسه) ومن الخطأ أن نطلب دليلًا على ما هو عادي.
ويقول روجر جيبسون : “المذهب الطبيعي عند كواين له مصدران وكلاهما سلبي، أحدهما هو اليأس من القدرة على تعريف الحدود النظرية في حدود الظواهر، وحتى عن طريق التعريف السياقي وسيكفي الموقف الكلاني Holistic، أو الموقف الذي يركز على النسق لإقناع هذا اليأس وهذا الموقف يقوض الأساس الذي تقوم عليه التجريبية التأسيسية.”
أما المصدر السلبي الآخر للمذهب الطبيعي فهو الواقعية العنيدة unregenerate realism وهي حالة عقلية قوية لدى العالم الطبيعي الذي لم يحس أبدًا بأي شكوك سوى الشكوك المتداولة في داخل العلم، وتقوض الواقعية العنيدة مجال النزعة الشكية وتتأسس الواقعية العنيدة على الرؤية التي تقول إن المعرفة العلمية تعد استمرارًا للحس المشترك الذي عنه نشأت، وإنه إن نطلب دليلًا على ما هو عادي يُعد خطأً مفهوميًا.” [xiii]
إن العلم هو إرثنا الثقافي الذي توارثناه منذ إنسان الكهوف حتى اليوم وهو لايزال متطورًا ومقتربًا من الحقيقة ومحددًا لها أيضًا، ومبادؤنا العلمية وقواعدنا المنهجية ليست اعتباطية وليست وليدة نزواتنا وأهوائنا ولكنها نتاج الاحتكاك بالواقع والتجربة والخطأ والتعديل، إنها أفضل إطار منهجي استطاعت الثقافة البشرية الوصول إليها بكامل إمكانيتها الإدراكية والمعرفية، فالعلم إنما يجسد أسلوب التفكير المثمر السليم، الذي يؤكد أنه أنجح وسيلة امتلكها الإنسان في التعامل مع العالم. نعم هي ليست مطلقة ونهائية وقابلة للتعديل، ولكنها أفضل ما لدينا، وعندما تكون هناك حاجة لذلك سنعدلها من داخل التراث العلمي البين-الذاتي الذي طورناه خلال الزمن، يقول كواين: “كل واحد منا يحمل تراثا علميًا وخزانًا من المثيرات الحسية التي لا تتوقف، والاعتبارات التي ترشده للتصرف، لملاءمة هذا الإرث للمثيرات الحسية – إن كانت عقلانية – هي اعتبارات برجماتية” [xiv]
العلم يبرر بعضه بعضًا ولا يحتاج إلى التبرير من خارجه، وهذا الادعاء لا يوقعنا في الدور، ولا يقذف بنا إلى الشك إننا على عكس ديكارت وأتباعه لا نحتاج إلى نقاط تأسيسية مطلقة حتى لا نقع في براثن الشك، بل إننا نمضي طلبًا للمعرفة مدفوعين بحاجاتنا البرجماتية ونزوعنا السيكولوجي واستعدادنا الطبيعي، مستخدمين أفضل مناهجنا وإمكانياتنا المعرفية لتكوين المخطط المفهومي الأفضل الذي يستطيع أن يتنبأ بالخبرات المستقبلية بما يتوافق مع حاجاتنا ومطالبنا، نعم يكون مخططتنا المفهومي وتصورنا عن العالم مفتوح للمراجعة ولكن لا يكون ذلك تشكيكًا لنا في حقيقة معرفتنا، تلك الحقيقة التي نؤمن بها يقين وثقة بكامل المعنى الاستعمالي (وليس الميتافيزيقي) لهاتين الكلمتين.
يقول كواين في فقرة عبقرية من كتاب الكلمة والشيء تلخص هدف وموضع هذا البحث:
“هل نكون إذا بعد بحوثنا السابقة قد رضخنا وقنعنا بقبول مذاهب نسبية في الحقيقية كالتي تقول أن الجُمل الخاصة بكل نظرية تكون صادقة داخل هذه النظرية فقط، ولن نكون عرضة لانتقادات من نوع أعلى؟!
لا ليس الأمر كذلك
الاعتبار المنقذ هو أننا نستمر في أخذ علمنا الكلي المحدد، ونظريتنا المحددة عن العالم Worldview، و نسيجنا الفضفاض من أشباه النظريات، أقول أن نأخذ كل هذا أيًا ما كان، بصورة جدية. على عكس ديكارت، نحن نمتلك اعتقاداتنا في اللحظة، حتى في أثناء التفلسف، إلى أن وعن طريق ما يطلق عليه بصورة فضفاضة؛ “المنهج العلمي” نغير بعضها هنا وهناك إلى الأفضل. من خلال مذهبنا الكلي المتطور، نحكم على الحقيقية بكل يقين وثقة ممكنة، نعم هي قابلة للتصحيح ولكن هذا يمضي دون أن نقوله.”[xv]
[i] د. زكي نجيب محمود – المنطق الوضعي ص 23 وبخصوص اليقين الرياضي – انظر الهامش رقم "i" في المقالة رقم 2 من هذه السلسلة. [ii] كواين – خمس معالم للتجريبية – من كتاب النظريات و الأشياء ص 72 [iii] وليم كلي رايت – تاريخ الفلسفة الحديثة ترجمة محمود سيد أحمد ص 421 [iv] كواين – خمس معالم للتجريبية – من كتاب النظريات و الأشياء ص 72 [v] ريكيتس - العقلانية و الترجمة و الإبستمولجيا الطبيعية – نقلا عن كتاب د. صلاح إسماعيل فلسفة اللغة والمنطق دراسة في فلسفة كواين ص 167 [vi] كواين –عن ماهو هناك – من كتاب من وجهة نظر منطقية - ص 10 [vii] كواين - الهوية والإشارة والتشيء - من كتاب من وجهة نظر منطقية –ص 78 [viii] كواين –عن ماهو هناك – من كتاب من وجهة نظر منطقية - ص 16-17 و آخرجملة في الإقتباس من: عقيدتان للتجريبية – من كتاب من وجهة نظر منطقية ص 45 [ix]كواين – الرد على وايت - نقلا عن الطبيعانية في الإبيستمولجيا – باتريك ريسو – موسوعة ستانفورد للفلسفة SEP [x]تشيس رين – الابستمولجيا المتطبعة – موسوعة الأنترنت الفلسفية IEP د صلاح إسماعيل – نظرية المعرفة المعاصرة ص 214-215[xi] [xii] كواين – الطبيعانية أو العيش في حدود وسائل المرء، نقلا عن كتاب د. صلاح إسماعيل نظرية المعرفة المعاصرة ص 216 [xiii] روجر جيبسون – كواين عن طبعنة الإبستمولوجيا نقلا عن كتاب "عن كواين : مقالات جديدة" تحرير باولو ليوناردي ص 95 و أنظر كلام كواين حول نفس الموضوع في مقال خمس معالم للتجريبية من كتاب النظريات والأشياء ص 72 [xiv] كواين – عقيدتان للتجريبية – من كتاب من وجهة نظر منطقية ص 46 [xv] كواين – الكلمة و الشيء ص 25
إعلان
